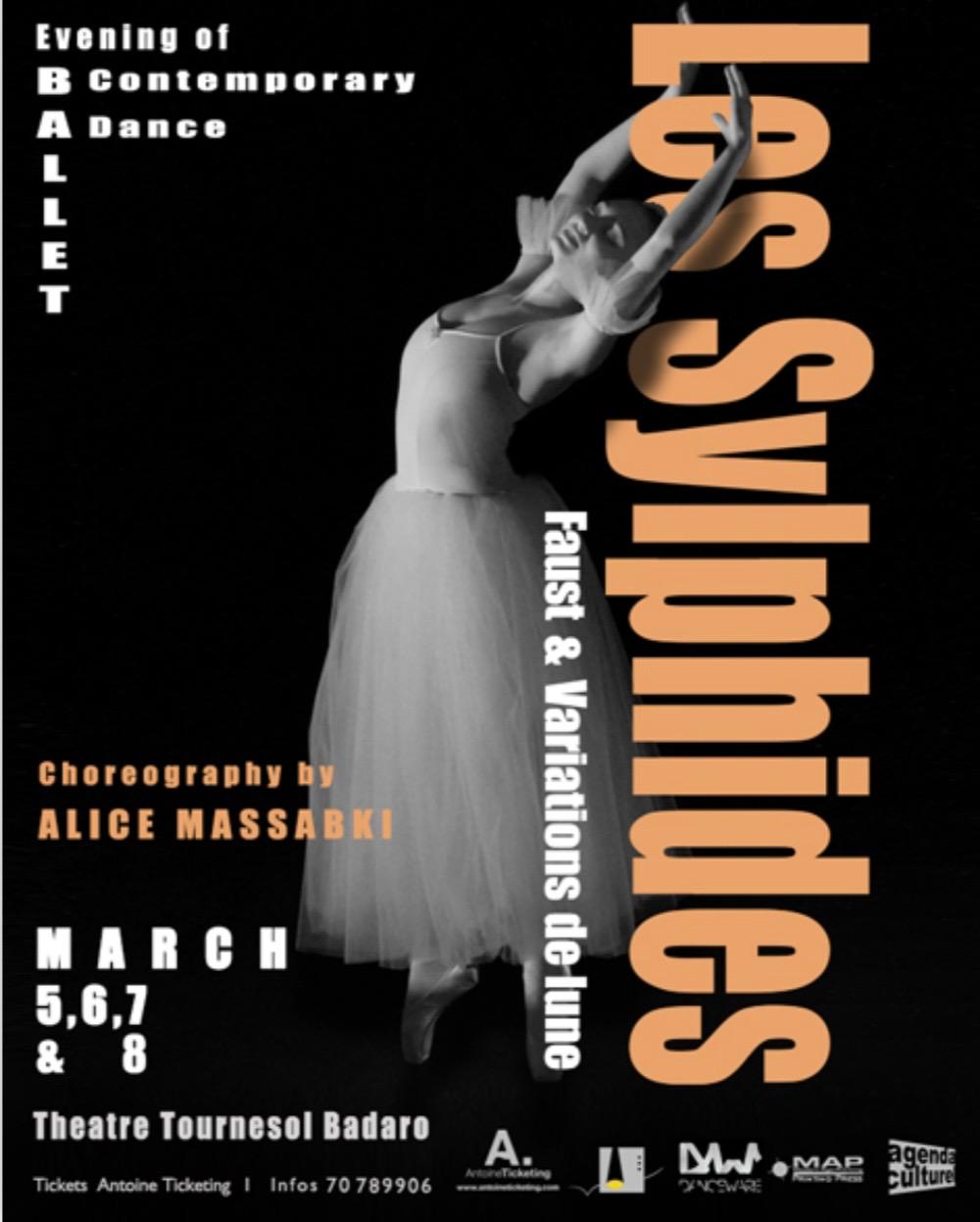بقلم الدكتور نبال موسى
بحكم مهنتي وحبي للسفر، زرت العديد من دول العالم ، وأقمت في أكثر فنادق العالم فخامة، وأكلت في أفخر المطاعم، ويمكنني القول أنني مثلاً أكلت في 95 بالمائة من أفخر مطاعم العاصمة الفرنسية المشهورة عالمياً، لكن أكلة واحدة أتذكرها وحدها بحنين خاص، أكلتها في مكان خاص، ولعلها إحدى أطيب الأكلات التي أكلتها حتى الآن. ربما ستستغربون كثيراً، لكن ما باليد حيلة، فهي الحقيقة، و” للناس في ما يعشقون مذاهب…”
ذهبت في العام 1973 مع خطيبتي الفرنسية التي اصبحت فيما بعد زوجتي في زيارة الى مدينة حلب الشهباء. كانت خطيبتي في السنة الأخيرة من التخصص في باريس في طب الأمراض الجلدية وتود الإطلاع عن قرب على “حبة حلب”، وهي بقعة مستديرة على البشرة تتركها لسعة ناموسة، ومنها ما قد تكون له انعكاسات خطيرة على الانسان، وهي موجودة بكثرة بين سكان حلب لأسباب لا مجال لذكرها هنا، ولهذا سمّيت باللغات الأجنبية ب “حبة حلب”، وكنا نريد في الوقت نفسه زيارة هذه المدينة التاريخية المعروفة بأسواقها القديمة الجميلة.
كنا نقيم في بيروت وقررنا ألا نستأجر سيارة وألا نركب سيارة أجرة، فقد أصرّت خطيبتي على ان نشتري بطاقتين في الدرجة الأولى في … هل تتذكرون؟ ” الأوتوموتريس”. والأوتوموتريس هي، لمن لا يعرف، قطار صغير شهير بهذا الاسم، صنعته في المانيا ماركة دو ديتريش. وللمصادفة، كانت الاوتوموتريس التي ركبناها تحتفل في ذلك اليوم بعيد ميلادها الخمسين، وتقوم بآخر رحلة لها من بيروت قبل دخولها مشغل الصيانة في حلب، على ما اخبرنا مهندس سوري شاب كان يجلس قريبا منا ويرافقها في هذه الرحلة التاريخية.
كانت رحلة لا تنسى. لم أعد أذكر كم استغرقت من الوقت، لكن لا أقل من اربع ساعات إن لم يكن أكثر، تمتعنا خلالها مائة مرة على الأقل بزمورها الشهير تووووووووت…تووووووت وشعرنا كأننا في فيلم من أفلام رعاة البقر. فقد كنا نجتاز قرى كثيرة بنيت بيوتها على مسافة قصيرة جدا من السكة الحديد، ولا بد من تنبيه الناس بأن حضرة الأوتوموتريس تمرّ من هنا، فابتعدوا!
كانت رحلتنا في شهر آب “اللهاب”، وفي الصحراء السورية كانت الحرارة لا تقل عن 40 درجة، وكانت الأوتوموتريس العجوز تتوقف من حين لآخر لتعبئة الماء الضروري لتبريد المحرك.
لعلّكم تقولون الآن: ما بالك تلف وتدور، أوصلنا الى المقصود! مهلاً، سنصل إن شاء الله، إذا وصلت الأوتوموتريس…سنصل الى المقصود الذي توقعتموه منذ بداية هذا المقال، لكن دعوني قبل ذلك أحكي لكم بعض التفاصيل اللطيفة.
جاء وقت الغداء ونحن ما زلنا في هذا القطار “السلحفاة” ! بُعَيد مدينة حماه أو أبعد بقليل. كنا احطتنا للأمر وتزودنا بسندويشات وزجاجة ماء، فأخرجنا زادنا وبدأنا تناوله. فتشجّع المهندس السوري الشاب وأخرج هو الآخر ما في كيسه، وفجأة سمعنا صوتاً كأنه صوت انفجار خفيف والمهندس الشاب يشتم ويلعن بغضب شديد. نظرنا فإذا به ملطخ من أعلى الى أسفل ببقع من السمن. إذ عندما فتح علبة اللحم البقري التي كان أعدّها لطعامه، ولشدّة الحرارة التي جعلت داخلها يغلي، انفجرت السمنة التي فيها عندما فتحها ملطخة وجهه وكل ثيابه.
وصلنا أخيرا إلى حلب، وتبادل الركاب العبارة التقليدية المستحقة فعلا في هذا القطار: “الحمدالله عالسلامة”. نزلنا في فندق ينصح به الدليل السياحي الذي كنا اشتريناه. وفي اليوم التالي أردنا زيارة المدينة ولكن على دراجة هوائية كسباً للوقت. ذهبنا الى محل يؤجّر هذه الدراجات واستأجرنا اثنتين أمام دهشة صاحب المحل التي فهمنا سببها فيما بعد. لم يطلب منا أي ضمان مالي ولا أي وثيقة. وعندما سألته ألا تريد بطاقة هويتي كضمان؟ أجابني بسخرية وابتسامة: ” أي لوين بدك تروح” ؟
أنطلقنا نتجول في المناطق التي كان الدليل السياحي يرشدنا اليها. وسرعان ما كان الأولاد يتجمعون ويركضون وراءنا ويضحكون، وبدا لي أن السبب هو ركوب خطيبتي الدراجة، إذ أن أحداً لم يشهد قبل ذلك الوقت في حلب امرأة تركب دراجة هوائية! وهكذا، كانت خطيبتي الفرنسية على ما استنتجت أول امرأة تركب دراجة هوائية في تاريخ حلب.
في اليوم التالي، توجهنا مشيا لزيارة الأسواق الأثرية الرائعة التي لم يبق منها اليوم شيء يذكر للأسف بسبب الحرب الطاحنة التي جرت في هذه المدينة. وبدأنا نكتشف: هنا سوق الحبالة، وهنا سوق الخياطين، وهنا سوق الكندرجية، والصاغة، والعطارين… الى ما هنالك من مهن. وكنا كلما مررنا بدكان كانت الكلمة التي نسمعها دائماً: تفضّلوا، أهلاً وسهلاً.
ثم جاء وقت الغداء، فقلت لخطيبتي تعالي نخرج من الأسواق لنبحث عن مطعم محترم نتغدّى فيه. وبينما نحن نحاول الخروج، استوقفت خطيبتي رائحة زكية تنبعث من “مطعم” صغير مفتوح كليا على السوق، لا يتسع لأكثر من سبعة أو ثمانية أشخاص، يأكل فيه بعض العمال. فقالت خطيبتي: هنا سنتغدّى! قلت: كيف؟ هنا؟ ألا ترين شكل المطعم؟ لا، لا… فأصرّت، وبما أنها خطيبة وضيفة، رضخت، ودخلنا، فأشار صاحب المطعم بيده الى طاولة صغيرة جلسنا أمامها. لم يسألنا ما نريد، لعلّه ظن من شكلينا أننا سائحين لا نتكلم العربية. ثم رأيته يأخذ صحنين كان زبونان قد فرغا من الأكل فيهما ويمررهما بسرعة تحت حنفية ماء، ثم يصب فيهما شيئاً ويأتي بهما إلى طاولتنا. كان الموقف محرجاً تجاه قواعد النظافة التي شهدناها: نأكل أم لا نأكل؟ أخيراً أكلنا بعد أن سلمنا أمرنا لله، وكان الطبق بامية باللحم والكزبرة مع الرز، وكانت تلك الوجبة من ألذ ما أكلت، ولم نُصَب بأي مكروه.
فتخيّلوا ! كل ما أكلته في أفخر المطاعم حول العالم، لا أتذكر الكثير منه، أما البامية باللحم والكزبرة في المطعم الشعبي في سوق حلب فقد بقيت في الذاكرة منذ 50 عاماً.
ترقبوا مقالا للإعلامي الدكتور نبال موسى كل يوم اثنين